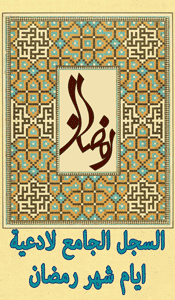حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
حول نص النبي على خلافة علي وعدم منازعته للمتآمرين
نص الشبهة:
إن قال قائل إذا كان من مذهبكم يا معشر القائلين بالنص إن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعده، وفوض إليه أمر أمته، فما باله لم ينازع المتآمرين بعد النبي في الأمر الذي وكل إليه وعول في تدبيره عليه أو ليس هذا منه إغفالا لواجب لا يسوغ إغفاله؟ فإن قلتم انه لم يتمكن من ذلك فهلا اعذر وأبلى واجتهد، فإنه إذا لم يصل إلى مراده بعد الأعذار والاجتهاد كان معذورا. أو ليس هو عليه السلام الذي حارب أهل البصرة وفيهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وطلحة والزبير، ومكانهما من الصحبة والاختصاص والتقدم مكانهما، ولم يحشمه ظواهر هذه الأحوال من كشف القناع في حربهم حتى أتى على نفوس أكثر أهل العسكر، وهو المحارب لأهل صفين مرة بعد أخرى مع تخاذل أصحابه وتواكل أنصاره، وانه (ع) كان في أكثر مقاماته تلك وموقفه لا يغلب في ظنه الظفر ولا يرجو لضعف من معه النصر. وكان عليه السلام مع ذلك كله مصمما ماضيا قدما لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد وهب نفسه وماله وولده لخالقه تعالى، ورضي بأن يكون دون الحق اما جريحا أو قتيلا، فكيف لم يظهر منه بعض هذه الأمور مع من تقدم والحال عندكم واحدة، بل لو قلنا انها كانت أغلظ وأفحش لأصبنا لأنها كانت مفتاح الشر واس الخلاف وسبب التبديل والتغيير؟. وبعد، فكيف لم يقنع بالكف عن التفكير والعدول عن المكاشفة والمجاهرة حتى بايع القوم وحضر مجالسهم، ودخل في آرائهم وصلى مقتديا بهم، وأخذ عطيتهم ونكح من سبيهم وانكحهم، ودخل في الشورى التي هي عندكم مبنية على غير تقوى، فما الجواب عن جميع ذلك اذكروه، فإن الأمر فيه مشتبه والخطب ملتبس؟.
Answer:
قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهو مما يخص الكلام في الإمامة، وقد استقصيناه في كتابنا المعروف بالشافي في الإمامة، وبسطنا القول فيه في هذه الأبواب ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة، لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من إشارة إلى طريقة الكلام فيها.
فنقول: قد بينا في صدر هذا الكتاب إن الأئمة عليهم السلام معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها، واعتمدنا في ذلك على دليل عقلي لا يدخله احتمال ولا تأويل بشئ، فمتى ورد عن احدهم عليهم السلام فعل له ظاهر الذنب، وجب ان نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم، كما فعلنا مثل ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى، وما لا يجوز على نبي من أنبيائه عليهم السلام.
فإذا ثبت إن أمير المؤمنين عليه السلام إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم عن الخطأ والزلل، فلابد من حمل جميع أفعاله على جهات الحسن ونفي القبيح عن كل واحد منها.
وما كان له منها ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة انه على غير ظاهره، فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه، وإلا كفانا في تكليفنا أن نعلم إن الظاهر معدول عنه، وأنه لابد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة.
وهذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة عليهم السلام وأقوالهم، ونحن نزيد عليها فنقول: ان الله تعالى لم يكلف إنكار المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلى غيره الا بشروط معروفة، أقواها التمكن. وان لا يغلب في ظن المنكر ان إنكاره يؤدي إلى وقوع ضرر به لا يحتمل مثله، وأن لا يخاف في انكاره من وقوع ما هو أفحش منه وأقبح من المنكر.
وهذه شروط قد دلت الأدلة عليها ووافقنا المخالفون لنا في الإمامة فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعي في وجوب إنكار المنكر، فمن أين أن أمير المؤمنين عليه السلام كان متمكنا من المنازعة في حقه والمجادلة، وما المنكر من أن يكون عليه السلام خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشيعته، ثم ما المنكر من أن يكون خاف من الإنكار من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الإسلام ونبذهم شعار الشريعة، فرأى ان الاغضاء أصلح في الدين من حيث كان يجر الإنكار ضررا فيه لا يتلافى.
فان قيل: فما يمنع من أن يكون إنكار المنكر مشروطا بما ذكرتم، إلا انه لابد لارتفاع التمكن وخوف الضرر عن الدين والنفس من امارات لايحة ظاهرة يعرفها كل احد، ولم يكن هناك شئ من امارات الخوف وعلامات وقوع الفساد في الدين. وعلى هذا فليس تنفعكم الجملة التي ذكرتموها لان التفصيل لا يطابقها.
قلنا: أول ما نقوله إن الأمرات التي يغلب معها الظن بأن إنكار المنكر يؤدي إلى الضرر، إنما يعرفها من شهد الحال وحضرها وأثرت في ظنه، وليست مما يجب أن يعلمها الغائبون عن تلك المشاهدة. ومن أتى بعد ذلك الحال بالسنين المتطاولة. وليس من حيث لم تظهر لنا تلك الأمرات ولم نحط بها علما، يجب القطع على من شهد تلك الحال لم تكن له ظاهرة، فإنا نعلم ان للمشاهد وحضوره مزية في هذا الباب لا يمكن دفعها، والعادات تقتضي بأن الحال على ما ذكرناه.
فإنا نجد كثيرا ممن يحضر مجالس الظلمة من الملوك يمتنع من انكار بعض ما يجري بحضرتهم من المناكير، وربما أنكر ما يجري مجراه في الظاهر، فإذا سئل عن سبب إغضائه وكفه ذكر أنه خاف لأمارة ظهرت له، ولا يلزمه ان تكون تلك الأمرة ظاهرة لكل أحد، حتى يطالب بأن يشاركه في الظن والخوف كل من عرفه. بل ربما كان معه في ذلك المقام من لا يغلب على ظنه مثل ما غلب على ظنه من حيث اختص بالأمرة دونه.
ثم قد ذكرنا في كتابنا في الإمامة من أسباب الخوف وأمارات الضرر التي تناصرت بها الروايات، ووردت من الجهات المختلفة ما فيه مقنع للمتأمل، وانه (ع) غولط في الأمر و سوبق إليه وانتهزت غرته، واغتنمت الحال التي كان فيها متشاغلا بتجهيز النبي صلى الله وآله عليه، وسعى القوم إلى سقيفة بني ساعدة، وجرى لهم فيها مع الأنصار ما جرى، وتم لهم عليهم كما اتفق من بشير بن سعد ما تم وظهر، وانما توجه لهم من قهرهم الأنصار ما توجه ان الإجماع قد انعقد على البيعة، وأن الرضا وقع من جميع الأمة و روسل أمير المؤمنين عليه السلام.
ومن تأخر معه من بني هاشم وغيرهم مراسلة من يلزمهم بيعة قد تمت ووجبت لا خيار فيها لأحد، ولا رأي في التوقف عنها لذي رأي ثم تهددوه على التأخر، فتارة يقال له لا تقم مقام من يظن فيه الحسد لابن عمه، إلى ما شاكل ذلك من الأقوال والأفعال التي تقتضي التكفل والتثبت، وتدل على التصميم والتتميم. وهذه امارات بل دلالات تدل على ان الضرر في مخالفة القوم شديد.
وبعد، فان الذي نذهب إليه من سبب التقية والخوف مما لابد منه، إذا فرضوا ان مذهبنا في النص صحيح، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة في مقام بعد مقام وبكلام لا يحتمل التأويل، ثم رأى المنصوص عليه أكثر الأمة بعد الوفاة بلا فصل، اقبلوا يتنازعون الأمر تنازع من لم يعهد إليه بشئ فيه، ولا يسمع على الإمامة نصا لان المهاجرين قالوا نحن أحق بالأمر، لان الرسول صلى الله عليه وآله منا ولكيت وكيت. وقال الأنصار نحن آويناه ونصرناه فمنا أمير ومنكم أمير. هذا، والنص لا يذكر فيما بينهم.
ومعلوم ان الزمان لم يبعد فيتناسوه ومثله لا يتناسى، فلم يبق إلا أنه عملوا على التصميم ووطنوا نفوسهم على التجليح، وأنهم لم يستيجزوا الاقدام على خلاف الرسول صلى الله عليه وآله في اجل أوامره وأوثق عهوده، والتظاهر بالعدول عما أكده وعقده، إلا لداع قوي وأمر عظيم يخاف فيه من عظيم الضرر، ويتوقع منه شديد الفتنة.
فأي طمع يبقى في نزوعهم بوعظ وتذكير؟
وكيف يطمع في قبول وعظه والرجوع إلى تبصيره وإرشاده من رآهم لم يتعظوا بوعظ يخرجهم من الضلالة وينقذهم من الجهالة؟
وكيف لا يتهمهم على نفسه ودينه من رأى فعلهم بسيدهم وسيد الناس أجمعين فيما عهده وأراده وقصده؟
وهل يتمكن عاقل بعد هذا أن يقول أي امارة للخوف ظهرت؟
اللهم الا أن يقولوا إن القوم ما خالفوا نصا ولا نبذوا عهدا، وإن كل ذلك تقول منكم عليهم لا حجة فيه، ودعوى لا برهان عليها، فتسقط حينئذ المسألة من أصلها، ويصير تقديرها إذا كان أمير المؤمنين (ع) غير منصوص عليه بالإمامة ولا مغلوب على الخلافة، فكيف لم يطالب بها ولم ينازع فيها؟ ومعلوم انه لا مسألة في ان من لم يطالب بما ليس له، ولم يجعل إليه، وإنما المسألة في ان لم يطالب بما جعل إليه.
وإذا فرضنا ان ذلك إليه، جاء منه كل الذي ذكرناه. ثم يقال لهم إذا سلمتم ان وجوب إنكار المنكر مشروط بما ذكرناه من الشروط، فلم أنكرتم ان يكون أمير المؤمنين عليه السلام انما أحجم عن المجاهدة بالإنكار، لان شروط إنكار المنكر لم تتكامل، إما لأنه كان خائفا على نفسه أو على من يجري مجرى نفسه، أو مشفقا من وقوع ضرر في الدين هو أعظم مما أنكره. وما المانع من أن يكون الأمر جرى على ذلك؟.
فان قالوا أن امارات الخوف لم تظهر.
قلنا: وأي امارة للخوف هي أقوى من الاقدام على خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله في أوثق عهوده وأقوى عقوده، والاستبداد بأمر لاحظ لهم فيه.
وهذه الحال تخرج من أن يكون امارة في ارتفاع الحشمة من القبيح إلى أن يكون دلالة، وإنما يسوغ أن يقال لا امارة هناك تقتضي الخوف وتدعو إلى سوء الظن إذا فرضنا ان القوم كانوا على أحوال السلامة متضافرين متناصرين متمسكين بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله، جارين على سنته وطريقته.
فلا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا لخوف من جهتهم طريق.
فأما إذا فرضنا انهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه، فالأمر حينئذ منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه له، وسوء الظن هو الواجب اللازم. فلا ينبغي للمخالفين لنا في هذه المسألة ان يجمعوا بين المتضادات، ويفرضوا ان القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه، وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها على أنا لا نسلم انه (ع) لم يقع منه إنكار على وجه من الوجوه، فإن الرواية متظافرة بأنه عليه السلام لم يزل يتظلم ويتألم ويشكو أنه مظلوم ومقهور في مقام بعد مقام وخطاب بعد خطاب.
وقد ذكرنا تفصيل هذه الجملة في كتابنا الشافي في الإمامة وأوردنا طرفا مما روي في هذا الباب، وبينا ان كلامه (ع) في هذا المعنى يترتب في الأحوال بحسب ترتبها في الشدة واللين، فكان المسموع من كلامه عليه السلام في أيام أبي بكر لا سيما في صدرها، وعند ابتداء البيعة له ما لم يكن مسموعا في أيام عمر، ثم صرح عليه السلام وبين وقوى تعريضه في أيام عثمان، ثم انتهت الحال في أيام تسليم الأمر إليه إلى انه (ع) ما كان يخطب خطبة ولا يقف موقفا الا ويتكلم فيه بالألفاظ المختلفة والوجوه المتباينة، حتى اشترك في معرفة ما في نفسه الولي والعدو والقريب والبعيد.
وفي بعض ما كان (ع) بيديه ويعيده أعذار وإفراغ للوسع، وقيام بما يجب على مثله ممن قل تمكنه وضعف ناصره. فأما محاربة أهل البصرة، ثم أهل صفين، فلا يجري مجرى التظاهر بالإنكار على المتقدمين عليه (ع)، لأنه وجد على هؤلاء أعوانا وأنصارا يكثر عددهم ويرجي النصر والظفر بمثلهم، لان الشبهة في فعلهم وبغيهم كانت زايلة عن جميع الأماثل وذوي البصائر، ولم يشتبه أمرهم إلا على اغنام وطغام ولا إعتبار بهم ولا فكر في نصرة مثلهم.
فتعين الغرض في قتالهم ومجاهدتهم للأسباب التي ذكرناها. وليس هذا ولا شئ منه موجودا فيمن تقدم، بل الأمر فيه بالعكس مما ذكرناه لان الجمهور والعدد الجم الكثير، كانوا على موالاتهم وتعظيمهم وتفضيلهم وتصويبهم في أقوالهم وأفعالهم.
فبعض للشبهة وبعض للانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام والحبة لخروج الأمر عنه، وبعض لطلب الدنيا وحطامها ونيل الرياسات فيها.
فمن جمع بين الحالتين وسوى بين الوقتين كمن جمع بين المتضادين. وكيف يقال هذا ويطلب منه (ع) من الإنكار على من تقدم مثل ما وقع منه (ع) متأخرا في صفين والجمل، وكل من حارب معه (ع) في هذه الحروب، إلا القليل كانوا قائلين بإمامة المتقدمين عليه (ع) ومنهم من يعتقد تفضيلهم على سائر الأمة، فكيف يستنصر ويتقوى في اظهار الإنكار على من تقدم بقوم هذه صفتهم، وابن الإنكار على معاوية وطلحة وفلان وفلان من الإنكار على أبي بكر وعمر وعثمان لولا الغفلة والعصبية، ولو انه (ع) يرجو في حرب الجمل وصفين وسائر حروبه ظفرا، وخاف من ضرر في الدين عظيم هو أعظم مما ينكره، لما كان إلا ممسكا ومحجما كسنته فيمن تقدم.
في بيعة علي للمتآمرين
فأما البيعة، فإن أريد بها الرضا والتسليم، فلم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام القوم بهذا التفسير على وجه من الوجوه. ومن ادعى ذلك كانت عليه الدلالة، فإنه لا يجدها. وان أريد بالبيعة الصفقة وإظهار الرضا، فذلك مما وقع منه (ع)، لكن بعد مطل شديد وتقاعد طويل علمهما الخاص والعام. وانما دعاه إلى الصفقة وإظهار التسليم ما ذكرناه من الأمور التي بعضها يدعو إلى مثل ذلك.
في حضوره مجالسهم
واما حضور مجالسهم فما كان عليه الصلاة والسلام ممن يتعمدها ويقصدها، وإنما كان يكثر الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيقع الاجتماع مع القوم هنا، وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص.
وبعد، فلو تعمد حضور مجالسهم لينهى عن بعض ما يجري فيها من منكر، فإن القوم قد كانوا يرجعون إليه في كثير من الأمور، لجاز ولكان للحضور وجه صحيح له بالدين علقه قوية. فأما الدخول في آرائهم، فلم يكن عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها على بعض ما شذ عنهم، والدخول بهذا الشرط واجب.
في الصلاة خلفهم
وأما الصلاة خلفهم، فقد علمنا ان الصلاة على ضربين: صلاة مقتد مؤتم بإمامه على الحقيقة، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وان كان لا ينويها فإن ادعي على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انه صلى ناويا للاقتداء، فيجب أن يدلوا على ذلك، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه. وان ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم، لأنه الظاهر.
إلا انه غير نافع فيما يقصدونه، ولا يدل على خلاف ما يذهب إليه في أمره (ع)، فلم يبق إلا أن يقال فما العلة في إظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلك غلبة القوم على الأمر وتمكنهم من الحل والعقد، لان الامتناع من إظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة، وقد قلنا فيما يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية.
في أخذه أعطيتهم
فأما أخذه الأعطية، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما يستحقه، اللهم الا أن يقال ان ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذممهم، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء.
لكن ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته، ان كان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال. عن ذلك انا نقول: ان تصرف الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغاية، وسوغت الحال للأمة الإمساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ على يده، ونكاح السبي وما شاكل ذلك.
وان كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعينه عليه نص عن ائمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال.
في نكاح السبي
فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الأمر وضوحا، بأن نقول ليس المشار بذلك فيه الا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه، وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان البلاذري 1 روى في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف، عن علي بن المغيرة بن الاثرم وعباس بن هشام الكلبي، عن هشام عن خراش بن اسمعيل العجلي، قال أغارت بنو أسد على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة في أول خلافة أبي بكر، فباعوها من علي عليه الصلاة والسلام، وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي عليه السلام فعرفوها واخبروه بموضعها منهم، فاعتقها ومهرها وتزوجها، فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم.
قال وهذا هو الثبت لا الخبر الأول، يعني بذلك خبرا رواه عن المدايني، انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن، فأصاب خولة في بني زبيدة وقد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب، وصارت في سهمه، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ولدت منك غلاما فسمه بإسمي وكنه بكنيتي، فولدت له (ع) بعد موت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فسماه محمدا وكناه أبا القاسم. وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق سؤال في باب الحنفية.
فأما انكاحه عليه السلام إياها، فقد ذكرنا في كتابنا الشافي، الجواب عن هذا الباب مشروحا، وبينا انه (ع) ما أجاب عمر إلى انكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور، أشفق معه من شؤون الحال ظهور ما لا يزال يخفيه منها، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى ان الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله (ع) رد أمرها إليه ففعل، فزوجها منه.
وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف انه على غير اختيار ولا إيثار. وبينا في الكتاب الذي ذكرناه انه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار، لا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة.
وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار على سائر انواع كفرهم، وانما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة.
وفعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة في أحكام الشرع، وبينا الجواب عن الزامهم لنا، فلو اكره على انكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك، وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين، وان كان عما في الشرع فالإجماع يحظر ان تنكح اليهود على كل حال. وما اجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبيح لكفر به، إذا اضطررنا إلى ذلك واكرهنا عليه.
فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟
قلنا لهم: وأي فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية.
فأما الدخول في الشورى، فقد بينا في كتابنا المقدم ذكره الكلام فيه مستقصى، ومن جملته انه عليه السلام لولا الشورى لم يكن ليتمكن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه. والأخبار الدالة على النص بالإمامة عليه، وبما ذكرناه في الأمور التي تدل على ان أسبابه إلى الإمامة أقوى من أسبابهم، وطرقه إلى تناولها اقرب من طرقهم، ومن كان يصغي لولا الشورى إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى.
وأي حال لولاها لكانت يقتضي ذكر ما ذكره من المقامات والفضائل، ولو لم يكن في الشورى من الغرض الا هذا وحده لكان كافيا مغنيا.
وبعد، فان المدخل له في الشورى هو الحامل له على إظهار البيعة للرجلين، والرضا بإمامتهما وامضاء عقودهما، فكيف يخالف في الشورى ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل (ع) ممضيا في الظاهر لعقوده حافظا لعهوده، وأول ما كان يقال له انك انما لا تدخل في الشورى لاعتقادك ان الإمامة إليك، وان اختيار الأمة للإمام بعد الرسول باطل، وفي هذا ما فيه. والامتناع من الدخول يعود إليه، ويحمل عليه. وقد قال قوم من أصحابنا انه انما دخل فيها تجويز ان ينال الأمر منها. ومعلوم ان كل سبب ظن معه، أو جواز الوصول إلى الأمر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه (ع) التوصل به الهجرة له. وهذه الجملة كافية في الجواب عن جميع ما تضمنه السؤال 2.