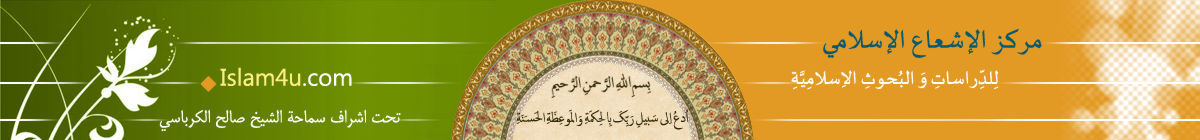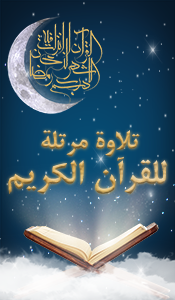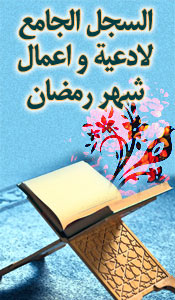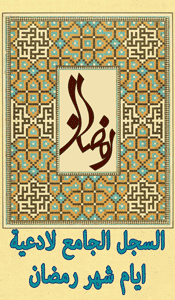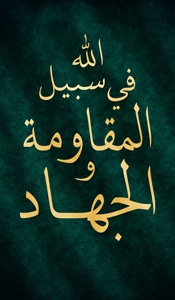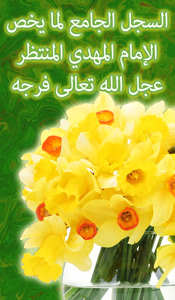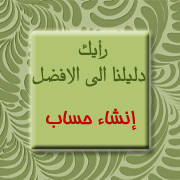حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
التراث والنهضة
هناك قراءتان في العلاقة بين التراث والنهضة، تطرحهما أدبيات النخب العربية والإسلامية. قراءة تقطع بين التراث والنهضة، وتفكك العلاقة بينهما، على خلفية التجاوز أو الاستحالة أو التباين والتصادم. وقراءة تربط بين التراث والنهضة، وتركب العلاقة بينهما، على خلفية التواصل والانتظام، وعدم الاستحالة والتباين. ومعظم الكتابات والأدبيات العربية والإسلامية التي تصنف على مجال الدراسات المعاصرة، تتصل بشكل أو بأخر بتلك القراءتين، أو أنها أساساً تدور في فلكها، أو لا تعدو أن تكون مقاربات لا تكاد تخرج عن إطار ونسق تلك القراءتين من حيث الفلسفة العامة. والاختلاف بين القراءتين، هو في الحقيقة اختلاف في المباني الفكرية، وفي طبيعة المنظورات الاجتماعية والفلسفية. القراءة الأولى تنطلق من خلفية أن التراث يعيدنا إلى الماضي، ويرجع بنا إلى الوراء، والنهضة هي تطلع إلى المستقبل، وتقدم إلى الأمام. والتراث هو ذاكرة الماضين، وهي ذاكرة جامدة بالنسبة لنا، والنهضة هي ذاكرتنا نحن، وهي ذاكرة متحركة. كما أن التراث حسب هذه القراءة يفصلنا عن الحضارة المعاصرة، ويضع بيننا وبينها مسافات تعوّق التواصل والتفاعل معها، بينما النهضة تربطنا بالحضارة المعاصرة، وتجعلنا نتفاعل معها، ونتواصل مع حركتها ومسلكياتها. وكثيرون الذين تحدثوا عن هذه القراءة في العلاقة بين التراث والنهضة، ومن هؤلاء الواضحين في التعبير عنها وبحماس واندفاع هاشم صالح، والذي ينتمي إلى المشروع الثقافي لمحمد أركون، وهو الذي عرف به إلى العالم العربي من خلال ترجمة مؤلفات أركون من الفرنسية إلى العربية. حين يتحدث هاشم صالح عن هذه القضية يقول (إننا لن نخرج من المأزق الذي نتخبط فيه حالياً ما لم نقم بمراجعة نقدية شاملة لتراثنا العربي الإسلامي. هذه المراجعة قد تتخذ هيئة تصفية حسابات تاريخية، لها أول وليس لها أخر. لأن التحجر العقلي هيمن أكثر مما ينبغي، وكذلك الجمود والانغلاق التاريخي الطويل. وهذه المراجعة لم تنجح حتى الآن في الساحة الثقافية العربية، على الرغم من كل ما قيل عن نقد العقل العربي، بل ربما كنا لم ندخل بعد في صلب الموضوع. ولكن هذه المراجعة الجذرية الشاملة كانت قد حصلت في أوروبا قبل مائتي سنة) ولذلك هو يدعونا إلى اقتفاء أثر تلك التجربة إذا ما أردنا الخروج من محتنا يوماً ما. أما القراءة الثانية فهي تنطلق من خلفية إن النهوض والتقدم لا يتحقق في أية أمة من الأمم إلا من خلال الانتظام في تراثها والتواصل معه، لا بالانقطاع عنه أو الانتظام في تراث أمة أخرى، مهما كانت عظمة تلك الأمة المتبعة، ودرجة تقدمها وتطورها. والأمم لا تتطور وتتقدم إلا بعجلة من داخلها، لا بعجلة من خارجها، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالغرب لم يكتشف طريقه إلى التقدم إلا بعد أن اكتشف طريقه إلى تراثه وانتظم في منظومته. والمسلمون هم الذين قاموا بهذا الدور فكان حقاً عليهم أن يصفه مستشرقو الغرب بالدور الحضاري للمسلمين، وذلك حينما استوعبوا التراث اليوناني والروماني وحفظوه ونقلوه فيما بعد إلى الغرب الذي فقد صلته به. لهذا فإن المسلمين قبل تقدم الغرب مثلوا له موقعية التراث والحداثة معا. موقعية التراث حينما تعرف الغرب على تراثه اليوناني والروماني عن طريق المسلمين، وموقعية الحداثة حينما اكتشف الغرب تقدم المسلمين الحضاري، وبالذات في ميادين العلوم والعلوم التجريبية بوجه خاص. لذلك يفسر الباحثون والدارسون لتاريخ النهضة الأوروبية وتقدمها في ميادين العلم بتعرف الغرب على المنهج التجريبي عند المسلمين. وهو المنهج الذي مازالت أوروبا إلى هذا اليوم تبني تقدمها عليه. أما الغرب اليوم فهو لا يمثل في نظر المسلمين إلا موقعية الحداثة من دون موقعية التراث، موقعية الحداثة للتقدم المذهل الذي أنجزه لمجتمعاته. الأمر الذي يستدعي من كل أمة تتطلع وتتحرك باتجاه التقدم أن تدرس تجربة الغرب في النهضة والتقدم. دراسة تكون على قدر كبير من الوعي والإدراك التاريخي والثقافي والحضاري لأجل أن لا تقع في تبعيته وتقليده. أما التراث فلا يمكن لأية أمة أن تستعير تراث غيرها، وتبني عليه تقدمها. والمفارقة بين القراءتين، أن القراءة الأولى ناظرة إلى الآخر وإلى فضاءه الثقافي، والقراءة الثانية ناظرة إلى الذات وفضاءه الثقافي. والنهضة ينبغي أن تكون نابعة من الذات، ومن تغيير بأنفسنا1.
- 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ ـ الأربعاء 22 ديسمبر 2004م، العدد 13997.