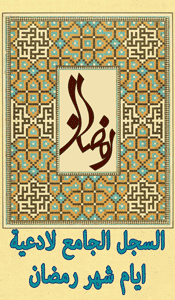حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
دلالات الهجرة النبوية المباركة
إرادتهم مقهورة، وجودهم مستغل، وإنسانيتهم مصادرة ..، فلا يتمتعون بالحقوق الممنوحة لغيرهم، مضافاً إلى أن عليهم أن يقوموا بكل الواجبات التي تطلب منهم.
وهذا كله، كان نتيجة حتمية حسب النواميس الإلهية الجارية في حياة المجتمعات، لان المجتمع عندما يعيش حالة الإبتعاد عن الله سبحانه، فإنه سوف ينحرف عن الصراط المستقيم الذي يوضح للإنسان ابعاد كل فعل من افعاله، وتصرف من تصرفاته، ليبقى ضمن الحدود التي تحفظه والآخرين في خط السيرالسوي.
تلك النظم والقوانين إذن، هي التي أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبين فسادها وانحلالها وعدم أخلاقيتها، مما يسقطها عن الاعتبار والتقديس والمهابة في القلوب، ليكون ذلك بداية الإنقاذ لذلك المجتمع مما هو فيه من ضلال وفساد وانحراف، وليحل محل ذلك الإدراك بالقيمة الذاتية للإنسان المتحققة بنفس وجوده، وأن للحياة أهدافاً كبيرة بعيدة كل البعد عن الأهداف الوضعية القريبة التي صاغها المستكبرون على مقاس مصالحهم ومنافعهم، ويجبرون الناس بالقوة والقهر على الإيمان بها، والعمل لها.
إلا أن الفئة الباغية والمسيطرة التي كانت تعيش الرفاهية على حساب الجوع والعطش لاكثرية أبناء المجتمع آنذاك، الذين كانوا مغلوبين على أمرهم، ومعتقدين أن لا قدرة لديهم على المقاومة والصمود أمام تلك القوة الغاشمة العاتية، ولأن القانون يفرض عليهم أن يكونوا كذلك، وأن العادات المتجذرة لا تسمح لهم بتجاوز حدودهم المسموح بها حسب القانون الجاهلي، فأولئك المستضعفون أراد لهم زعماء قريش أن لا يعوا واقعهم الأليم والمرير أو إذا أدركوا واقعهم، فلا قدرة لديهم على التغيير والتبديل، رأوا في دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمل بالحرية والخلاص من كل ما يقيدهم ويكبل حركتهم.
وقبل الدخول في توضيح الأبعاد والدلالات للهجرة النبوية المباركة، لا بد من الإشارة إلى أمر قد يساعدنا في فهم الشارع في مجريات الأمور بعد الهجرة عن حركة الأمور قبلها، إذ إن المرحلة المدنية شكلت منعطفاً أساسياً في تسريع خطى المسيرة الإسلامية بنحو لم يكن موجوداً في المرحلة المكية، فخلال ثلاثة عشر عاماً متصلاً ببعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدخل في الإسلام إلا الأعداد القليلة، أما بعد الهجرة، تمكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في السنة الثامنة من دخول مكة فاتحاً منتصراً معلناً نهاية عبادة الأوثان والأصنام، ومطهراً للقبلة المشرفة ومؤذناً ببداية عصر عبادة الله الواحد القهار، وهذه النقطة بالذات هي التي تستوقف الإنسان في محاولة لتفسيرها، لأن لذلك مدخلية أساسية في فهم حركة التغيير السريع في موازين القوى والتحالفات وغير ذلك من الأمور المرتبطة بذلك.
وهنا نقول: إن كل نظرية جديدة تريد فرض وجودها على ساحة الواقع لمجتمع ما، لا بد من أن تلقى في أول الأمر معارضة قوية وعدم قبول بنحو من الأنحاء من المجتمع الذي تسود فيه قوانين متعامل بها ومعترف بها شرعياً ضمن تركيبة ذلك المجتمع، وكلما كانت تلك القوانين متجذرة ومنغرسة في ضمير الناس وحياة الأمة، كلما كانت درجة الرفض أشد، ودرجة القبول أخف، لأن الارتكاز القائم قد يوحي للأكثرية بشرعية ما هو موجود، بنحو يمنع الأفراد بشكل عام من قبول الطروحات الجديدة، والرفض هذا سوف يكون مبدئياً من القوى المهيمنة والمسيطرة على الوضع القائم، والتي تستفيد أولاً من الواقع المتحقق، لأنها تمتلك العناصر الأساسية للسلطة والقوة، ويتبعها في الرفض كل المرتبطين بها والمستفيدين منها، لأنهم سوف يرون هذا الوضع الجديد الذي يريد فرض نفسه عدواً لدوداً يعمل على حرمانهم من مناصبهم، ويأخذ منهم أسباب قوتهم ومصدر سيطرتهم، ويأتي بعد هؤلاء في الرفض أفراد الأمة العاديون الذين قد يكونون من المعتقدين بصواب الحالة الموجودة نتيجة عمقها وتجذرها في إدارة شؤون الأمة، بحيث قد لا يخطر في بالهم فساد القانون الموجود المتحكم بحياتهم وهذا ما يعبر عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: (الناس أعداء ما جهلوا).
ويمكن التأكيد على النقطة السابقة من خلال ملاحظة أن الإنسان عادة هو ابن للخط أو الظرف الذي يعيشه، خاصة إذا كان غير قادر على امتلاك المعرفة والتحليل العقلي للواقع القائم بحيث يستنبط فساده وعدم لياقته ليحكم حياة الناس، وبالأخص إذا كانت الحالة القائمة تؤمن له كل ما يريد من أمور حياتية ومعاشية تعين على أن يعيش مستكفياً، فمثل هؤلاء ومن لحق بهم، لن يكونوا مستعدين لأن يتخلوا عن كل ذلك، مقابل الإيمان بنظرية جديدة لم تأخذ دورها بعد في حياة الأمة، لأنهم قد يعتبرون ذلك نوعاً من القفزة في المجهول، أو بمعنى أن الضمانة للمستقبل الواعد غير أكيدة، لعدم تحقق مصداق واقعي لذلك، ومجرد الالتزام النظري الواعد بالخير والرفاه والسلام، فإن هذا وحده لا يكفي للطمأنينة للتخلي عن الموجود الفعلي والالتحاق بركب المؤمنين بالفكر الجديد أو الطريقة الجديدة، حتى ولو كانت قادرة، فيما لو تمكنت من السيطرة على حركة الواقع أن تفي بكل وعودها والتزاماتها من كل ذلك، تبرز قيمة ومكانة وعظمة الموقف الرسالي الذي اتخذه الذين آمنوا بالفكرة الجديدة التي جاء بها الإسلام الذي أوحى به الله للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن أولئك استطاعوا أن يكسروا الطوق الذي يقيد حركة المجتمع ضمن الموازين الخاصة به، وتمكنوا من أن يتجاوزوا الخط الحاضر المرير الذي يعيشونه، كل ذلك، من أجل أن يؤمنوا بالله حق الإيمان، ويتمسكوا بالعقيدة الجديدة لبناء الحياة بجانبيها المعنوي والمادي، لان الأوائل هم الذين كانت تتوقف على استمرارهم وصمودهم إمكانية نجاح الدعوة أو فشلها.
فالمسؤولية الكبرى إذاً كانت ملقاة على عاتق أولئك المؤمنين الأوائل، الذين تحملوا الضغوطات المتنوعة، وصمدوا في وجه الإرهاب والظلم الذي مورس ضدهم، فإرادتهم القوية، وعزمهم الراسخ، وإيمانهم القوي، هو الذي دفعهم إلى المضي قدماً في السير مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلمهم بأن ذلك السبيل هو وحده الكفيل بإثبات وجودهم، ليجعلوا الآخرين من المنتظرين والمترددين أو اللامبالين الذين قد يتمكنون من أن يجعلوا الفكرة الجديدة قابلة للنفاذ إلى عقولهم وقلوبهم وتستقر فيها كما استقرت فيهم.
والإسلام- "الدين المكمل للرسالات السماوية وآخرها" الذي أُنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه من التشريعات والنظم التي تصحح حركة المجتمع - كان قادراً على إنجاز المهمة عبر بنائه لهيكلية الأمة بالنحو الموافق للهدف من وراء خلق الإنسان، ولكن مع هذا، فإن سلامة العقيدة وصحة تشريعاتها لم تكن في مورد القبول من أبناء المجتمع المكي بالخصوص فضلاً عن سائر أنحاء الجزيرة العربية يومذاك، وهذا الأمر جاء على وفق القانون الاجتماعي المتعارف في هذا المجال، حتى قيل بأن "العادات قاهرات"، خاصة وأن الناس المغلوبة على أمرها لا تنظر إلى المستقبل نظرة موضوعية، لأنها ترى فيه صورة واقعها الذّي تعيش فيه، وقد يكون هذا الواقع من القساوة والضغط بحيث يجعل هؤلاء قبل غيرهم، يعيشون حالة الإحباط التي تجعلهم خائفين أو مترددين في الدخول إلى الدعوة الجديدة خوفاً من القوى المسيطرة، أو قلقاً على فقدان حاضرهم نتيجة عدم ضمان مستقبلهم، وهذا بالتحديد ما يمكننا أن نقول بأنه حصل مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع قومه عندما طرح عليهم الإسلام كبديل، بل إن المقربين منه من الأهل والعشيرة كانوا أول المخالفين والمعاندين له عندما أمره الله بإنذار عشيرته بقوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ 1، حيث دعاهم إلى وليمة مرة أولى ثم اتبعها بالثانية، ومع هذا لم يلق منهم إلا الصد والرفض والاستهزاء حتى إنهم لم يكلفوا أنفسهم طرح الأسئلة للاستفسار عن هذا الدين الجديد الذي يدعوهم إليه، من هنا، نفهم أن طوال الفترة المكية من بداية العقيدة الاسلامية لم يؤمن بالدين الجديد سوى أفراد محددين في العدد والتأثير، مع كل ما تحملوه من الأذى والتعذيب ليتخلوا عن إيمانهم وليتراجعوا، لكنهم استطاعوا بعون الله عزوجل أن يثبتوا مع الله، ومن حالة الاقتناع بما دعاهم إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتجاوزوا مراحل الخطر بعد أن استشهد البعض منهم أثناء التعذيب على يد الجلاوزة والمستكبرين آنذاك، وإن كان أسلوب الضغط والإرهاب قد أثر سلبياً على تنامي حركة الرسالة في المرحلة المكية بنسبة كبيرة، لأنه استطاع أن يفرض جواً من الخوف بوجه كل الذين يريدون الدخول في خط الإيمان عبر الالتزام بدعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأن الذين يشعرون بأن هذا هو ما سيكون عليه مصيرهم، قد يجبنون ويتوقفون عن الاندفاع، لأن أسلوب الضغط والإرهاب ينتج في عقولهم وقلوبهم فكرة عدم إمكانية تحقيق ما يهدفون إليه عند إيمانهم بالدين الجديد.
وبعد انسداد كل سبل متابعة تبليغ الرسالة في الأوساط المكية، كان لا بد من البحث عن الأرض البديلة، لتكون نقطة البداية والانطلاق، خاصة بعد وفاة أبي طالب الذي تمكن بما له من المكانة والمهابة أن يلعب دوراً كبيراً في حماية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أثناء حياته، فكان الحامي له والمعين والنصير ضد الفئة الباغية والمستكبرة، وفي نفس العام توفيت خديجة الكبرى تلك الزوجة الصالحة المؤمنة المجاهدة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى سمي ذلك العام "عام الحزن" وكان الذي سماه كذلك هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه وقد رثى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عمه الراحل بقوله: (رحمك الله يا عم، ربيت صغيراً وكفلت يتيماً ونصرت كبيراً، فجزاك الله عني وعن الإسلام خير جزاء العاملين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون ثم بكى وأبكى معه من حوله أيضاً وقد ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) (والله ما نالت قريش في شيئاً أكرهه إلا بعد موت أبي طالب).
الخروج إلى الطائف
كان لا بد بعد اشتداد الأزمة، والقساوة التي أظهرتها قريش في التعامل مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد موت عمه الناصر والحامي والكفيل من البحث عن الأرض البديلة لمتابعة مسيرة الرسالة، التي لا بد لها من أن تنتقل إلى طور آخر من أطوارها، وهو السعي لتأمين الجماعة البشرية الحاضرة للالتزام، وتأسيس المجتمع على قاعدة الإيمان بالله والإسلام، وبما أن الاستمرار في مكة صار مضراً بعد الفترة الطويلة نسبياً من الإنذار والتبليغ، ولم تعط النتائج المتوخاة منها، بسبب العناد والإصرار على الرفض، اتّجه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الطائف وهي المدينة القريبة من "مكة المكرمة" وهذا حسب طبيعة الأشياء التي تقول بأن الإنسان إذا لم يستطع أن ينفذ أمراً ما في مكان وموطن مفترض، فيجب البحث عن البديل الأقرب في المسافة والتأثير، من هنا كان الاختيار الأول للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمدينة الطائف، فقصدها وتوجه إلى سادة ثقيف فيها وهم إخوة ثلاثة ((عبد ياليل بن عمرو ومسعود وحبيب)) فلم يتجاوبوا معه، ومع هذا بقي فيها قرابة عشرة أيام يجول ويبلّغ لعله يجد الآذان الصاغية والقلوب الواعية إلا أن النتيجة كانت غير ما توقع، حتى أن كبراء الطائف أغروا عبيدهم بالتهجم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فضربوه بالحجارة وآذوه، فجلس (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى جانب حائط في ظل شجرة وقال: (اللهم اني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين).
هذه القضية أثارت غضب العتاة من قريش، مما جعلهم يزيدون من أذيتهم ومضايقتهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وناله منهم من الأذى ما لم يعرف من قبل، وكان أشدهم عليه هو عمه "أبو لهب" الذي تفرغ لمهمة ملاحقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتكذيب مقالته عند كل الناس الذين كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعوهم إلى الله والإسلام والنصرة، حتى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كلمته المعروفة (ما أوذي نبي قط مثل ما أوذيت).
بيعة العقبة الأولى
بعد الرجوع من الطائف، استمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تبليغ الدعوة، فكان لا يترك جماعة قادمة إلى مكة من سائر أنحاء الجزيرة إلا دعاها إلى الإسلام، إلى أن بدأت الطريق تتعبد شيئاً فشيئاً بعون الله القدير، من خلال بيعة العقبة الأولى بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفد من الأنصار من المدينة المنورة قوامها إثنا عشر رجلاً من الذين لاقوه وبايعوه وكان من بينهم عبادة بن الصامت ,
وكانت البيعة على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولايأتوا بهتاناً يفترينه وبعث معهم النبي عند رجوعهم مصعب بن عمير لتعليمهم أحكام الإسلام، وبث الرسالة في مجتمع المدينة المنورة، وقام مصعب بالمهمة خير قيام، كان من نتيجتها ازدياد أعداد المسلمين، حتى إذا جاء موسم الحج بعد البيعة الأولى، خرج مصعب ومعه الأشراف والسادات من مجتمع المدينة والتقوا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتواعدوا على اللقاء سراً حتى لا يفتضح الأمر في الشعب، فحصل اللقاء وطلب منهم اختيار إثني عشر رجلاً يمثلونهم فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، وقالوا: (ابسط يدك فبسط يده، فبايعوه على نصرته والدفاع عنه وبذل الأموال والأنفس دونه) وسميت البيعة هذه ((بيعة العقبة الثانية)).
علمت قريش بالأمر، وأيقنت ساعتئذ أن موازين القوى قد بدأت بالاختلال لصالح النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد وجود الأنصار الذين كثروا فصاروا قوة يمكن الاعتماد عليها للدفاع عن الإسلام، ولم يعد يحتاج الأمر إلى أكثر من أن يخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى المدينة، ليقود المسيرة ويكملها من حيث وصلت إليه، وكانت قريش تفكر كيف تضرب هذه الحركة الجديدة والقفزة الكبيرة قبل أن يميل الميزان كلياً لصالح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجاء الأمر الإلهي للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بترك مكة والتوجه إلى المدينة في الآيات التالية:
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ... ﴾ 2 ... ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ 3.
وهنا بدأ المسلمون من أهل مكة ينسحبون منها للذهاب إلى المدينة كما أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلمت قريش بذلك، فكانت ترد من تعثر عليه منهم بالقوة إلى مكة.
هجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة
بعد هجرة الأكثرية من المسلمين إلى المدينة المنورة، بدأ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتخطيط للهجرة أيضاً، وكانت قريش تعرف ذلك أيضاً، فمن أجل هذا اجتمع زعماء قريش في "دار الندوة" وتباحثوا أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانت الآراء متعددة، فرأي يقول يسجن حتى يموت، ورأي مع نفيه والبراءة منه، ورأي ثالث وهو انتخاب فتىً قوي وشجاع من كل قبيلة، ويحمل كل منهم سيفاً ليضربوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضربة واحدة فيموت منها، بهذا يتفرق دمه في القبائل كلها، مما يجعل عملية الأخذ بثأره متعسرة جداً على بني هاشم.
اختار زعماء قريش هذا الرأي الثالث، فاختاروا الفتية المكلفين تنفيذ المهمة، وعينوا الليلة لذلك أيضاً، وقد أشار القرآن إلى تلك المؤامرة كما يقول المفسرون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ 4.
علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بخطة قريش للخلاص منه، فلم يعد أمامه إلا الرحيل عن مكة بسرعة ليلحق بالمسلمين في المدينة، وترك أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) لينام بدلاً عنه في فراشه ظناً من القوم أنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وخرج (صلى الله عليه وآله وسلم) وقرأ عند خروجه من حصار القوم للمنزل آية السد ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ 5. وعندما جن الليل هجموا على الدار وهم يظنون أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما زال فيها فإذا بأمير المؤمنين (عليه السلام) الذي افتدى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودين الله بنفسه، يقف في وجههم، وإذا بالمفاجأة تبهرهم، فولوا مدبرين يجرون أذيال الخيبة والخسران، وفوّت عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بلطف من الله وتأييد الفرصة للخلاص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
واستمرت العناية الإلهية في حماية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورعايته، بعدما علمت قريش بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد خرج من داره، وتوجه إلى المدينة، فلحقوا به، وجعلت قريش جائزة قيّمة لمن يقتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو يأسره وهو "مائة ناقة" لكن كل ذلك لم يكن مانعاً من وصوله إلى المدينة المنورة سالماً معافى، وخرج أهلها لاستقباله (صلى الله عليه وآله وسلم).
دلالات الهجرة النبوية المباركة
إلى هنا نجد أن حركة الهجرة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت ضرورية وفي ظرفها المناسب، ولم يكن مبررها الهروب من القتل الذي كانت تعد له قريش لإسكات صوت الحق وإنما للهجرة دلالات أهم من مجرد البقاءعلى الحياة، وتلك الدلالات لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب المشروع والمخطط لتنفيذه والعارف إلى أي مدى يجب أن يصل على مستوى تحقيق الأهداف. من هنا، يمكننا أن نقول بأن دلالات حركة الهجرة هي التالية:
أولاً: (تأمين الأرض البديلة لاستمرار الدعوة)
كان قد سبق من الكلام أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد انسداد السبل في وجهه للتبليغ في مكة، توجه إلى الطائف بهدف تأمين الأرض البديلة، الا أن النتيجة كانت سلبية جداً كما سلف، مما اضطر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للبحث عن البديل عن الطائف أيضاً، ولعل اختياره الأول للطائف ناشئ من قربها من الموطن الأصلي لحركة الدعوة وهي "مكة" لكن بعد سقوط هذا الاختيار بسبب الرفض والمعاندة لدعوة الحق، كان لا بد من البحث عن أي مكان لأن الاستمرارية كانت تقتضي ذلك باعتبار مضي سنوات طويلة، والدعوة لم تستطع أن تمتد في الأوساط بسبب العراقيل والموانع التي كانت تقف عائقاً.
ولهذا كانت البيعة الأولى، ثم الثانية بعدها، مع أهل المدينة، ثم إرسال مصعب إليهم لتعليمهم الإسلام، من أجل ضمانة نجاح حركة الهجرة، لأن أي فشل جديد للهجرة، كان يمكن أن يؤدي إلى الإحباط بدرجة كبيرة للمسلمين الذين ما زالوا على تمسكهم بالدين الجديد، لهذا تعامل النبي (صلى الله هليه وآله وسلم) مع قضية الأرض البديلة تعاملاً وثيقاً، ولهذا لم تتم الهجرة إلا بعد اكتمال مراحل تلك الخطوة، بحيث صار مجتمع المدينة مهيئاً لاحتضان الإسلام ونبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنحو الذي يحقق الفرض من الهجرة إليها لمتابعة المسيرة.
ثانياً: (أسلمة المجتمع طبقاً لاحكام الإسلام)
لمجرد استقرار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة، بدأ بأسلمة المجتمع على كل المستويات المعروفة آنذاك، لتشكيل النموذج البديل عن كل الواقع القائم، وتمكين تلخيص أهم الخطوات على طريق ذلك ما يلي:
أ ـ بناء المسجد: لا شك في أهمية المسجد عند المسلمين عموماً، فهو عنوان إسلامية المنطقة التي يوجد فيها بنحو غالب، مضافاً أنه المكان الأساس الذي تنطلق منه حركة الإنسان في علاقته وارتباطه بالغني المطلق سبحانه وتعالى، وهو المكان الذي يتلقى فيه الإنسان من المعرفة بالإسلام لأنه مدرسة للتعليم ايضاً يتزود منها ما يريده التزاماً وتمسكاً بالعقيدة، يضاف إلى كل ذلك ما يمكن أن يشكله المسجد من عامل تقارب وألفة وتحابب بين المسلمين، ويكفي الرجوع إلى الرويات لدرك الأهمية الكبيرة لهذه الأماكن.
من هنا، لا يعقل أن يغفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن هذا الدور المهم في رحلة تكوين المجتمع على الأسس الإسلامية، وإبراز ذلك في الشكل والصورة توصلاً إلى تقوية المضمون الإسلامي أيضاً في المجتمع الوليد والجديد.
ولهذا كان المسجد هو أول خطوة من خطوات تثبيت الحالة الإسلامية في المدينة لإشعار الجميع بالإستقرار لأن المسجد يوحي بنحو عام بذلك.
ب – توثيق صلات التقارب والتآخي بين المسلمين: كانت قبيلتا "الأوس والخزرج" قبل الإسلام في نزاع دائما ومستمر بشكل قلق لحياة المجتمع، إلا أنهم بعد الدخول في الإسلام، خفت حدة تلك المشاكل كثيراً، وبعد هجرته إلى المدينة، عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)على تقوية أواصر العلاقات بين الطرفين ونجح في ذلك إلى حد بعيد مما كشف عن اقتدار كبير ووعي تام للواقع القائم وكيفية تحويل السلبيات التي يمكن أن تعيق حركة الإسلام في المدينة، إلى ايجابيات يتحرك الجميع من خلالها لخدمة الإسلام، بل سعى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً إلى التقريب بين أهل المدينة وبين المهاجرين المسلمين الذين تركوا "مكة" فراراً بدينهم، لإشعار الجميع بأنهم متساوون في نظر الإسلام، وهذا ما تخبرنا عنه كتب السيرة التي تتحدث عن قصة المؤاخاة التي آخى فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الفريقين، فكان يؤاخي واحداً من المهاجرين مع واحد من الأنصار من أهل المدينة لتعميق حالة الوحدة بين الجميع.
حتى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد استطاع في تلك المرحلة الأولى من استمالة اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة على قاعدة تحصين المدينة وتقويتها في مواجهة كل الآخرين من قريش وغيرها، ولعل الذي ساعد على ذلك هو توقع اليهود إمكانية استمالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إليهم وتجييره لخدمة أهدافهم ومصالحهم، خاصة إذا لاحظنا أن المسلمين في الفترة الأولى من الهجرة كانوا ما زالوا يصلون إلى بيت المقدس الذي يرى فيه اليهود قبلتهم التي يتوجهون إليها في عبادتهم.
ولا شك في أن اتباع هذا الأسلوب من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي ساعد على تركيز الأوضاع في مجتمع المدينة وتثبيتها تحسباً لأي أمر طارئ قد يحصل، وحول هذه النقطة بالذات يقول الأستاذ هيكل في كتابه "حياة محمد" (صلى الله عليه وآله وسلم): ولكن العمل السياسي الجليل حقاً والذي يدل على أعظم الإقتدار ذلك ما وصل إليه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من تحقيق وحدة يثرب ووضع نظامها السياسي.
ولا شك بأن الأجواء التي شاعت وسادت في مجتمع المدينة بعد هذه الخطوات كانت أجواء إيجابية تسمح للجميع بأن ينطلقوا لخدمة الإسلام والمجتمع بالنحو الذي يؤمن كل مصالح المسلمين وغيرهم من خلال شعور كل فرد بقيمة وأهمية الدور الذي يقوم به.
ثالثاً: (تبيان قصور النظام الجاهلي عن بناء الحياة السعيدة)
لا شك أن مجتمع المدينة حصل فيه انتقال نوعي في العلاقات والروابط والصلات بين أفراد المجتمع، فالجميع متساوون أمام عدالة الإسلام، فلا قوي إلا صاحب الحق ولا ضعيف إلا من كان عليه الحق، وعاشت الناس آمنة على أنفسها ومالها وأعراضها، كراماتها مصانة، وحرياتها محفوظة، وإنسانيتها محترمة، وكل هذه الأجواء لم تعهدها مجتمعات الجاهلية من قبل، كما أوضحنا ذلك في مقدمات كلامنا، حيث كان مجتمع الجاهلية قائماً على موازين القوى المجردة عن الأخلاق والمعاني الإنسانية، وكان تصنيف الناس يتم على أساس تلك الموازين مع إغفال النظرعن المعاني الإنسانية الفاضلة التي لم يكن لها وزن أو تأثير.
وبما أن التجربة الإسلامية قد حققت لنفسها واقعاً ملموساً تراه الناس وتتحسسه، فقد لاحظت الفوراق بين النموذجين والطريقتين في إدارة شؤون المجتمع، ولهذا نتج عن تلك المراقبة من الناس، دخول الأفواج الكثيرة في الدين الجديد، عندما شعرت بالنتائج الجيدة التي لا ريب أن الإدارة الحكيمة والمنظمة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمخلصين من مساعديه هم الذين مكنوا من نجاح التجربة إلى الحد الذي جعل الإسلام بعد سنوات قليلة القوة الأكبر في المنطقة، ولم تمض السنة الثامنة من الهجرة إلا وتم إعلان نهاية عبادة الأصنام والأوثان إلى الأبد، وبدأ عصر عبادة الله الواحد القهار، وكان ذلك من خلال فتح "مكة" في السنة الثامنة للهجرة.
رابعاً: نشر الإسلام في العالم
إنطلاقاً من أن الرسالة الإسلامية هي رسالة عالمية لا تختص بشعب دون آخر، كما تصرح الآية الكريمة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ 6 وبعد استقرار الأوضاع في المدينة، عمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الاتصال بالدول المحيطة بالجزيرة العربية كالأمبراطورية الفارسية والرومية والحبشية، والى الملوك المعروفين آنذاك كملك الإسكندرية واليمامة والبحرين وتخوم الشام وغيرهم، عبر إرسال موفدين يحملون كتبه المتضمنة لطلب الاستجابة للدعوة بالدخول في الدين الجديد والتسليم لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.
ولا شك أن الذي دفع بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك هو المسؤولية الشرعية الإلهية المكلّف بتحملها والقيام بأعبائها وهي السعي لنشر الإسلام في أكبر بقعة ممكنة من الأرض واستيعاب العدد الأوفر من الناس لتقوية هذا الدين وتمكينه في الأرض ليكون البديل عن كل واقع الانحراف والظلم والفساد آنذاك، وفي ظل العقائد المنحرفة عن خط الله سبحانه من الوثنية وعبادة النار والاديان الإلهية المحرفة كالمسيحية واليهودية التي دخلت إليها الكثير من مفردات العقائد الوثنية فاختلطت بها حتى ضاعت المعالم الأساسية لتلك الأديان والتزامها الناس مع ما فيها من ذلك الخليط والمزيج الغريب عن جوهرها. وهذه الخطوة سوف نرى آثارها المستقبلية على مسيرة الدعوة الإسلامية، لأنها فتحت المجالات والآفاق أمام المسلمين الأوائل للانطلاق في إكمال مسيرة الإسلام وتقويتها عبر الإنتشار العظيم الذي تحقق في وقت قصير بلحاظ الظروف الموضوعية آنذاك من صعوبة الاتصال والتواصل بين الأمم والشعوب نتيجة لعدم توافر الوسائل لذلك في ذلك العصر المفتقر إليها.
الدلالات العامة للهجرة النبوية المباركة
ما ذكرناه في الفقرة السابقة كانت الدلالات الخاصة لحركة الهجرة، وماذا كانت تأثيراتها المباشرة على تحرك الرساليين لتثبيت مواقع الدولة الإسلامية في تجربتها الأولى لتصليب عودها وتقويتها، وضمان النجاح في تنظيم وضع المجتمع انطلاقاً من الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، وما ساعد على ذلك أيضاً هو عملية التشريع لكل الأوضاع التي كانت تتم على مراحل لضمان حسن التقيد والتنفيذ، ثم التقدم نحو خطوات جديدة وهكذا.
الا أن هناك دلالات أخرى يمكن استفادتها من حركة الهجرة وهي ما سوف نصطلح على تسميتها بـ "الدلالات العامة للهجرة" التي لا تختص بزمن معين أو مكان كذلك، بل هي نوع من الدروس العملية للمجاهدين الرساليين العاملين في مجالات التبليغ ونشر الإسلام، ليستفيدوا منها في حركتهم ضمن الواقع الذي يتواجدون فيه، بحيث قد تعترضهم العقبات والموانع والمشاكل المتنوعة، فيحتاجون في مواجهة ذلك إلى التجارب الرائدة التي قد تشكل بصيص أمل يزرع في النفوس القوة والإرادة على الاستمرار، بدلاً من الضعف أو التخاذل والاستسلام الذي قد يعتمده البعض للتهرب من المسؤولية الرسالية بحجة عدم الاقتدار على مواجهة الأوضاع الصعبة والحرجة والمعوقة للمسيرة.
ومن الدلالات العامة يمكننا أن نختار منها ما يلي:
الدلالة الأولى: تأمين الانتشار الأوسع للرسالة
إن المسلم في حركته لتبليغ الإسلام إلى الناس ليس مضطراً لأن يحصر اهتماماته في بقعة معينة، وذلك لأن العالم كله هو ساحة الحركة وميدان الدعوة، وهذا من صميم العقيدة الإسلامية كونها عالمية وشاملة بخطابها لكل البشر على اختلاف القوميات والألسن والأعراق، والمطلوب من المجاهدين الرساليين إيصال الرسالة إلى أوسع مدى يتمكنون فيه من ذلك، ومن هنا فإن العامل للإسلام عند اختياره لبقعة معينة لا بد أن يلحظ الأهمية المعنوية والمادية لتلك البقعة ومدى تأثيرها في المحيط الذي تتواجد فيه، لأن هذا الإختيار يلعب دوراً إيجابياً في حال النجاح أو سلبياً في حال الفشل، إلا أن عدم النجاح لا يعني الوصول إلى مرحلة اليأس، لأن عمومية الرسالة تعطي المجال وتفتح الأبواب أمام العاملين للانتقال إلى بقعة أخرى وهكذا الأمر إلى أن يتأمن للرسالة المؤمنون بها والأنصار لكي تتنامى الحركة وتستمر وتقوى.
وبعبارة أخرى إن كل مسلم يحمل عنوان "المبلّغ" بالتزامه وعمله وهو مسؤول عن تبليغ الرسالة، وهذه المسؤولية هي التي كانت من أهم الأسباب لوصول كلمة الإسلام إلى مختلف بقاع العالم التي لم يصل إليها المسلمون عبر حركة منتظمة وهادفة.
وهذه الدلالة تمكن العاملين من الاستفادة منها في حركتهم المعاصرة في مجال حركة الرسالة سواء بين المسلمين أو بين غيرهم، خاصة مع توافر الوسائل التي تتيح للعاملين الانتقال بسرعة من المكان الذي لم يحققوا فيه النجاح إلى أماكن أخرى يختارونها للانطلاق من جديد.
ولهذا فإن كل أنواع العقبات والمشاكل والمعوقات لا يمكن أن تقف سداً منيعاً في وجه العاملين، وها هي تجربة الرسول (صلى الله عيله وآله وسلم) ما زالت حية أمامنا، فعندما لم ينجح في "مكة" ذهب إلى "الطائف" فلما لم ينجح أيضاً، لم ينهزم، بل ازداد إصراراً في البحث عن الموطن المناسب إلى أن تحقق ذلك في "يثرب" فانتقل إليها للانطلاق من هناك في حركة جديدة مع مجتمع أمّن للرسالة وللنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأجواء الملائمة للاستمرار والنجاح وتحقيق الأهداف.
وهكذا نجد في التجربة الرائدة في هذا الزمن المعاصر للإمام الخميني "قده"،الذي اضطرته الظروف في إيران إلى الابتعاد قهراً على يد النظام البهلوي والنفي إلى تركيا، ثم منها إلى العراق ليقود الثورة من هناك، فلما منعته السلطة البعثية، أراد الإنتقال إلى الكوبت فلما منعته من دخول أراضيها، انتقل إلى فرنسا ليقود شعبه من هناك، وقاد الثورة إلى النصر المبين، ولم تكن كل تلك العوائق مانعاً امامه من الحركة والجهاد والسعي الدؤوب للعمل في سبيل إيصال صوت الإسلام إلى الأمة والشعب في إيران وفي كل العالم الإسلامي.
الدلالة الثانية: التخطيط الواعي المنظم والهادف
إن كل هدف يريد الإنسان الوصول إليه، لا بد له من أن يضع الخطة التي يرى أنها تؤدي الغرض منها، ولا بد من أن يلحظ فيها كل الظروف والعوامل المحيطة التي قد تكون مقربة من الهدف أو مؤدية إلى بعد الوصول إليه، حتى يكون تخطيطه سليماً ومحققاً للنتائج، وهذا الأمر لا يمكن التغافل عنه أو التهاون والتسامح فيه، لأنه بدون التخطيط المنظم والمدروس الناتج عن فهم الواقع فهماً حقيقياً موضوعياً لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف.
من هنا، فإن المطلوب من العاملين الرساليين مراقبة الساحات التي يعملون ضمنها ودراستها بعناية ودقة من أجل فهم الواقع الذي يتحركون فيه، لأن ذلك هو المدخل الصالح للاستفادة من كل ما يمكن تسخيره من طاقات وإمكانات وغير ذلك من ضمن المخطط الواعي والهادف والذي يحسن استغلال الفرص لمصلحته.
وتجربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في تحصين مجتمع المدينة تعتبر نموذجاً عظيماً في هذا المجال حيث حدد الأهداف تبعاً لأولويات حركة الصراع بعد دراسة الواقع القائم من حوله، فنرى أنه هادن اليهود في المدينة أولاً ليأمن شرهم، وانصرف إلى مقارعة قريش وزعامتها قبل أي شيئ آخر، لأن سقوط "مكة" كانت في نظر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أهم من محاربة اليهود في المدينة، لما للحرب معهم من آثار سلبية على المجتمع الإسلامي الوليد والحديث العهد والمحتاج إلى الأجواء الهادئة للاستقرار وشعور أبناء المجتمع بالأمن والسلام والطمأنينة لأسباب متعددة لا مجال لذكرها هنا.
وهكذا نجد التخطيط الدقيق والمنظم لتأمين القيادة التي ستقود الأمة بعده، وكيف كان يختار الظروف المناسبة لإبراز شخصية أمير المؤمنين (عليه السلام) كشخصية قيادية ترتكز من خلال الإختيارات الدقيقة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للحالات المؤثرة في ذلك الإدارة كما في قضية حصن خيبر وواقعة الأحزاب وقبل كل ذلك المبيت على فراش النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند إرادة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الخروج من مكة مهاجراً إلى المدينة.
من هنا، يحتاج العاملون بقوة إلى دراسة تجربة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دراسة معمقة وواعية في محاولة جادة لاستنباط كل ما يمكن منها من دلالات يستفيد منها المجاهدون الرساليون العاملون للإسلام، لأن المعركة في حقيقتها واحدة وهي بين ((خط الله والمؤمنين به، وبين خط الشيطان والمنحرفين معه))، وكما يخطط أولئك لمنع المؤمنين من تحسين مواقعهم وتقويتها، فكذلك ينبغي على المؤمنين أن يفعلوا ذلك، ليعرفوا كيف يتمكنون من إفشال كل المخططات الساعية لضربهم وتحجيمهم وإلغاء دورهم الرسالي الكبير.
نسأل الله أن يلهمنا السير على خطى نبينا الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن يرزقنا شفاعته ويحشرنا معه ومع أهل بيته الطاهرين المعصومين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين7.
- 1. القران الكريم: سورة الشعراء (26)، الآية: 214، الصفحة: 376.
- 2. القران الكريم: سورة الحج (22)، الآية: 39 و 40، الصفحة: 337.
- 3. القران الكريم: سورة الحج (22)، الآية: 41، الصفحة: 337.
- 4. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 30، الصفحة: 180.
- 5. القران الكريم: سورة يس (36)، الآية: 9، الصفحة: 440.
- 6. القران الكريم: سورة الأنبياء (21)، الآية: 107، الصفحة: 331.
- 7. نقلا عن الموقع الرسمي لسماحة الشيخ محمد توفيق المقداد حفظه الله.