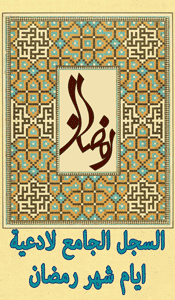حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
مَغزى البيعة مع المعصومين (عليهم السلام)
بسم الله الرحمن الرحيم
شوهد في الآونة الأخيرة من يجعل بيعة الاُمّة للمعصوم شرطاً في ولايته التي تكون بمعنى ولاية الحكم، ووجوب إطاعته في أحكامه التي تصدر عنه بوصفه حاكماً دون التي تصدر عنه بوصفه مبلّغاً لشريعة الله. ولا فرق في هذا الشرط بين رسول الله (صلى الله عليه و آله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، فمن لم يبايَع منهم من قبل الاُمّة على ذلك لم يكن له حقّ الحكومة وتنحصر وظيفته عندئذ في تبليغ الشريعة.
وقال: إنّ نظريّة العقد الاجتماعي المنسوبة إلى روسو يعود جذرها في الحقيقة إلى زمن نوح بل إلى زمن آدم ، وإنّها بجذرها تكون من بقايا رسالات الرسل التي أتوا بها من السماء، وخلاصتها في جذرها عبارة عن أنّ الحكومة في أساسها ترجع إلى العقد كعقد البيع أو النكاح أو غير ذلك. فالاُمّة تملك بنفسها أمرها ثُمّ تعطي ذلك إلى الحاكم من دون فرق في ذلك بين الحاكم المعصوم والحاكم غير المعصوم تماماً، من قبيل أن الرجل يملك مالاً فينقله إلى المشتري بعقد البيع أو يملك منفعة فينقلها إلى المستأجر بعقد الإيجار، أو أنّ المرأة تملك نفسها فتملّكها بالمقدار المشروع في عقد الزواج للزوج وما إلى ذلك من العقود.
وبما أنّ هذا القائل ينطلق من جذور دينيّة وليس من قبيل روسو، فلهذا فرّق بين المعصوم وغيره بأنّه ما دام المعصوم موجوداً تجب على الاُمّة بيعة المعصوم ولا تجوز لها بيعة غير المعصوم، فلو خالفوا هذا التكليف وبايعوا غير المعصوم وتركوا بيعة المعصوم لم تجز للمعصوم ممارسة السلطة والحكم، ولكن الاُمّة قد ضلّوا وعصوا. أمّا في حال غيبة المعصوم فعلى الاُمّة أن يبايعوا الفقيه العادل، فهذا القائل يعترف بولاية الفقيه، إلّا أنّه يقصد بولاية الفقيه أنّه يجب على الاُمّة أن يبايعوا أحدهم ومن وقعت له البيعة تحقّق له حقّ الحكم.
وهذا الجزء الأخير من كلامه ليس خاصّاً به بل هذا أمر سجّله أخيراً عدد من العلماء الأعلام مع إثبات ذلك بالأدلّة والبراهين، وسواء كان هذا صحيحاً أم باطلاً فهو ليس في حديثنا هذا مصبّاً للبحث، وقد بحثناه مفصّلاً في كتابنا المسمّى بولاية الأمر في عصر الغيبة.
أمّا العقد الاجتماعي لروسو فقد بحثناه مفصّلاً في كتابنا المسمّى بأساس الحكومة الإسلاميّة، وليس مصبّاً لبحثنا الآن وإنّما الذي نريد تناوله للبحث هنا هو أنّ حكومة المعصوم وأقصد بالذات الرسول (صلى الله عليه و آله) والأئمّة الاثني عشر ـ صلوات الله عليهم ـ هل هي مشروطه بالبيعة، وأنّ بيعة المعصومين لا يتصوّر لها مغزى إلّا إعطاء حقّ الحكومة الذي تملكه الاُمّة للمعصوم وتنقله إليه بالعقد الاجتماعي، أو من المحتمل أو المتعيّن أن يكون لها مغزى آخر غير هذه التي فهمها هذا القائل؟
ولعلّه لا يوجد قبل هذه الآونة الأخيرة شيعيّ يعتقد باشتراط ولاية الحكم للمعصوم بالبيعة. بل قيل لي: إنّ هذا القائل أيضاً تراجع عن رأيه.
ولكنّني على رغم ذلك رأيت لزاماً عليّ بحث هذا الموضوع خشية أن تكون هذه الشبهة سارية في بعض الأذهان، أو أن يقول البعض: إنّ ما وقع لعدد من المعصومين من البيعة دليل على أنّ فهم الشيعة وأئمّتهم وقتئذ كان هو هذا، وإن اختفى هذا الفهم عن الشيعة بعد ذلك في عصر الغيبة. وعليه فموضوع بحثنا هذا مايلي:
ما هو مغزى البيعة التي وقعت للمعصومين (عليهم السلام)؟
ذلك أنّ أهم شيء استدلّ به هذا القائل على كون البيعة شرطاً في ولاية المعصوم الحكوميّة هو ما ثبت بضرورة من التأريخ من وقوع البيعة من النبيّ (صلى الله عليه و آله) والإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهما السلام)، وصريح القرآن شاهد على البيعة مع النبيّ (صلى الله عليه و آله)، وضرورة التأريخ تُثبت أنّ كلّ هؤلاء المعصومين لم يقوموا بشؤون الحكومة من الجهاد بالسيف وغير ذلك إلّا بعد تحقّق البيعة معهم. وفعل المعصوم كقوله حجّة بلا إشكال، وهذا يعني أنّ هذا القائل لم يكن يرى لمغزى هذه البيعات إلّا تفسيراً واحداً وهو أنّها كانت لأجل إعطاء الاُمّة ولاية الحكم للنبيّ أو الإمام؛ لأنّ هذا هو حقّ الاُمّة وما لم ينتقل إلى المعصوم بالعقد الاجتماعيّ لم تصحّ للمعصوم ممارسة الحكم.
في حين أنّ هذه البيعات تحتمل تفسيرين:
أحدهما: ما ذهب إليه هذا القائل من تفسيرها بفكرة العقد الاجتماعي المعطي ولاية الأمر للمعصوم .
وثانيهما: أنّ المعصوم على رغم أنّ له ولاية الأمر والحكومة بتشريع من قبل الله تعالى لم يكن من المقرّر إلهيّاً أن يُرضخهم لما له من حقّ الحكومة بالإكراه الإعجازي.
كما أنّه لا تُجبر الاُمّة على الأحكام الاُخرى كالصلاة والصوم بالجبر الإعجازي وإلّا لبطل الثواب والجزاء؛ لأنّ الناس يصبحون مسيَّرين عن غير اختيار. بل كان من المقرّر أن يصل المعصوم إلى السلطة بالطرق الاعتياديّة. ومن الواضح أنّ الوصول إلى السلطة بالطريق الاعتيادي وبغير الإعجاز ينحصر في تواجد ناصرين له من البشر، فكان أخذ البيعة منهم لأجل التأكّد من وجود ثلّة كافية من الاُمّة تعهّدوا بنصر المعصوم والعمل معه في جهاده وسائر اُموره الحكوميّة، ولولا هم لعجز المعصوم حسب القوّة البشريّة ومن دون الإعجاز عن تحقيق السلطة والحكومة خارجاً.
وصحيح أنّ فعل المعصوم كقوله حجّة ولكن الفعل بما أنّه أمر صامت وهو في كثير من الأحيان يحتمل تفسيرين أو أكثر، لا يكون حجّة لإثبات أحد التفاسير، في حين أنّ القول أمر ناطق وفي غالب الأحيان يكون ظاهراً في تفسير معيّن، وبالتالي يكون حجّة في إثبات ذاك التفسير.
وإذا دار أمر تلك البيعات بين التفسيرين اللذين ذكرناهما كان أمامنا طريقان لحلّ اللغز:
الطريق الأوّل: أن نلتمس من نفس مكتنفات الفعل وكيفيّته ما يكون قرينة قطعيّة أو عرفيّة لتعيين أحد التفسيرين.
والطريق الثاني: أن نفترض عدم وجود قرينة من هذا القبيل فيسقط الفعل عندئذ عن الحجّيّة لإثبات أحد التفسيرين، فنرجع إلى الكتاب أو السنّة القوليّة لمعرفة الحكم. بل أحياناً يوضّح لنا الكتاب أو السنّة القوليّة بشكل قطعي ما هو تفسير ذاك الفعل الذي كان في نفسه مجملاً.
ونحن نسلك هنا لتوضيح الأمر كلا هذين الطريقين، ولكنّنا قبل سلوكهما نشير إلى ما قد يقال بعد فرض انحصار تفسير ما وقع من البيعة بمعنى العقد الاجتماعي الموجب لولاية الأمر، من أنّ هذا التفسير بعد تسليمه لا يثبت نفي ولاية الحكم عن المعصوم قبل البيعة؛ وذلك لاحتمال أن يكون لولاية الحكم مصدران: أحدهما: التعيين الإلهي بالنصّ والثاني: العقد الاجتماعي، وأراد المعصوم أن يحقّق لنفسه المصدر الثاني على رغم امتلاكه للمصدر الأوّل ورغم كفاية المصدر الأوّل له. ولعلّه كانت الحكمة في ذلك أن تتعلّم الاُمّة المصدر الثاني أيضاً كي يفيدهم في حالات فقد المعصوم التي لم يعيّن فيها شخص ما بالنصّ.
ومن هنا يتّضح أنّنا لو استظهرنا من بعض النصوص ولاية الحكم للإمام قبل البيعة، فحتّى لو انحصر تفسير البيعة بالعقد الاجتماعيّ لم يضرّ ذلك بما هو مسلّم لدى الشيعة من ثبوت ولاية الحكم للمعصوم بالنصّ.
أمّا كيفيّة سلوكنا للطريقين المشار إليهما آنفاً فهي مايلي:
الطريق الأوّل: اقتناص قرينة قطعيّة أو عرفيّة من نفس الكيفيّة التطبيقيّة للفعل لتفسير ذلك الفعل.
وهذه القرينة إن كانت فهي في صالح التفسير الثاني للبيعة دون الأوّل، أي في صالح أنّ أخذ البيعة كان لأجل التأكّد من وجود الناصر الذي لم يكن المفروض إيجاده بالقهر الإعجازي، والذي لم يكن يمكن عملاً تحقيق السلطة والحكم بدونه، وليست في صالح التفسير الأوّل وهو كون هذه البيعة عقداً اجتماعيّاً لتحقيق مصدر لولاية الأمر والحكم. وتلك القرينة هي أنّه لو كانت البيعة ملحوظة كعقد اجتماعيّ ناقل لحقّ الاُمّة في نفسها إلى المعصوم بقرار بينهما كما هو الحال في نظائرها من العقود، لكان المتوقّع أن يكون أحد طرفي هذا الحقّ هو المعصوم والطرف الآخر كلّ الاُمّة، إمّا بمعنى بيعة الأكثريّة الساحقة بنحو لا يتخلّف عنها إلّا النزر القليل الذي لا ينفي تخلّفه عرفاً صدق عنوان التوافق والعقد بين الاُمّة والمعصوم، وإمّا بمعنى أنّ الاُمّة كلاًّ لها توافق سابق على تمشية رأي الأكثريّة مع فرض أنّ البيعة تُحقَّق من أكثريّة الاُمّة، على رغم أنّ المخالف لم يكن نزراً قليلاً بل كان كثيراً جدّاً، فإن تخلّف القسم الأقلّ حتّى ولو كان أقلّ من القسم الآخر بصوت واحد فقط لا يضرّ بعد ما كان هناك اتّفاق بين الفريقين الأقلّ والأكثر على انّ الذي يحكمهم جميعاً هو رأي الأكثر. وهذا البيان الثاني هو المفهوم من الكلمات المنقولة عن روسو، ولكنّنا ـ كما قلنا ـ لسنا الآن بصدد مناقشة روسو.
ولو كانت البيعة ملحوظة لا عقداً اجتماعيّاً بين الاُمّة والمعصوم يورث الحقّ بل تأكّداً من وجود القدر الكافي من الناصر الذي به يستطيع المعصوم المبايع الحرب مع الأعداء أو إقامة الحكم، لكان المترقّب اكتفاء المعصوم ببيعة من يكفيه للنهوض بالأمر على رغم عدم اتّفاق أكثريّة ساحقة على تلك البيعة ولا توافق سابق بين الفئتين على تحكيم رأي الأكثريّة ولو غير الساحقة.
والذي وقع في غالب البيعات التي ثبتت بالتأريخ القطعيّ للمعصوم هو الثاني لا الأوّل، فهذا رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد بايعته أقلّيّة مسلمة وخالفته الأكثريّة الكافرة، واكتفى بذلك في تثبيت حكمه على أهل الكتاب بكونهم مخيَّرين بين الالتزام بالإسلام أو الالتزام بإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يكن هذا تبليغاً لتشريع الله لهم إن شاؤوا عملوا به وإن شاؤوا خالفوه؛ إذ لو كان كذلك لما كان هناك أيّ داع لأحدهم للالتزام بالجزية.
وهذا عليّ اكتفى ببيعة من حضرها من المسلمين ولم يكن قد دخل أهل الشام في البيعة معه ولا كانوا قد أعطوا رضاً بنفوذ بيعة الآخرين عليهم، فما الذي أدخلهم في أحد طرفي العقد حتّى ينفذ العقد عليهم؟ وما معنى قول عليّ : «أيّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شَغَب شاغب استُعتِب، فإن أبى قوتل. ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثُمّ ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار»1؟
وما معنى كتاب عليّ لمعاوية: «إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ. وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباع غير سبيل المؤمنين وولاّه الله ما تولّى»2؟
وروى ذلك أيضاً نصر بن مزاحم في كتاب وقعة صفّين مع شيء من التفصيل مصدّراً الكلام بقوله: «أمّا بعد، فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام؛ لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ... »3.
فلو كانت هذه الكلمات ـ بعد فرض صدورها ـ تشير إلى العقد الاجتماعيّ ووجوب الوفاء بالعقد لطرفيّ العقد لأنّهم ارتبطوا به كارتباط المتبايعين بعقد البيع أو المتناكحين بعقد النكاح ونحو ذلك، لكان لمعاوية أو للناس الآخرين المخالفين أن يجيبوا عليّاً: متى أصبحنا طرفاً للعقد كي تُلزِمنا بذلك؟! أفلا يكفي هذا قرينة على أنّ هذه النصوص إن صحّت فهي واردة احتجاجاً على معاوية أو على القوم على أساس إلزامهم بما التزموا من صحّة خلافة الخلفاء السابقين، وشرعيّة ما وقع لهم من البيعة وافتراض أنّ نفس البيعة أورثث حقّ الحكم ولم تصدر هذه النصوص على أساس منطق يؤمن به نفس المتكلّم؟
وممّا يشهد لكون البيعة على أساس فكرة أخذ الميثاق فحسب لا على أساس فكرة تحصيل حقّ الولاية والحكم ما ورد من مطالبة عليّ معاوية بالبيعة، كما جاء في كتاب له إلى جرير بن عبدالله البجليّ لمّا أرسله إلى معاوية: «أمّا بعد، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل، وخذه بالأمر الجزم، ثُمّ خيّره بين حرب مُجلية أو سلم مخزية، فإن اختار الحرب فانبذ إليه، وإن اختار السلم فخذ بيعته. والسلام»4.
وفي كتاب له إلى معاوية في أوّل ما بويع له بالخلافة:
«فبايع من قبلك وأقبل إليّ في وفد من أصحابك»5. وتوضيح المقصود أنّه إن كانت بيعة من بايعوا عليّاً من المهاجرين والأنصار كافية في حصول ولاية الحكم له على كلّ الاُمّة، وكان الهدف من البيعة تحصيل هذه الولاية كما هو الظاهر الأوّلي للنصوص السابقة التي حملناها على الاحتجاج برأي الخصم، إذن فلا معنى لمطالبة معاوية بالبيعة، ولا يبقى مجال إلّا لمطالبته بالطاعة بعد أن تمّت البيعة ولو من قبل قسم من المسلمين، وإن كانت بيعة من بايعوه غير كافية لتحصيل ولاية الحكم كان لمعاوية تمام الحقّ بعد عدم إيمانه بفكرة العصمة في رفض البيعة، بحجّة أنّ ولاية الحكم لم تتحقّق بعد لعليّ ولا داعي لمعاوية في الاشتراك في تحقيق ذلك. وهذا بخلاف ما لو فرضنا البيعة على أساس فكرة أخذ الميثاق بعد ثبوت الحقّ سابقاً، فيكون هدف عليّ من مطالبة معاوية بالبيعة أخذ الميثاق على الطاعة منه تأكّداً من أمر خارجيّ وهو دخوله في صفّ المناصرين لعليّ ، لا تحقيقاً لموضوع الحكم التشريعي بثبوت ولاية الحكم. أفلا يكفي كلّ هذا شاهداً على أنّه لا يمكن تفسير كلّ هذه النصوص ـ إن صحّت ـ إلّا على أساس الاحتجاج وأخذ الخصم بمبدأ يؤمن به، وهو فكرة مغلوطة عن البيعة غير قابلة للقبول في رأي المتكلّم نفسه.
وكذلك الحسن بعد أن تمّت له البيعة من قبل أهل الكوفة استمرّ في الحرب ضدّ معاوية وأهل الشام التي كانت في زمن عليّ ، على رغم أنّ معاوية وأهل الشام لم يكونوا طرفاً للعقد الاجتماعي مع الحسن حتّى تكون للحسن سلطة شرعيّة عليهم في رأي من يرى أنّ السلطة تأتي على أساس العقد.
وكذلك الحسين اكتفى في إقدامه على الخروج لإقامة حكومة إسلاميّة لجميع المسلمين بما تمّت له من بيعة أهل الكوفة، في حين أنّ أهل الشام لم يكونوا قد بايعوه.
فكلّ هذا يعني أنّ هذه البيعات كانت بيعة في حدود التأكّد من وجود الناصر بالقدر الذي تفترض كفايته للنهوض، وهذه قرينة عرفيّة على أنّ مغزى البيعة كان عبارة عن أخذ الميثاق بالنصر كي يتمّ التأكّد المعقول من وجود الناصر حين ينهض المعصوم بالأمر، ولم يكن مغزاها عبارة عن العقد الاجتماعي مع الاُمّة لانتزاع حقّ ولاية الحكم منهم، وإلّا لما كان المقدار الذي حصل من البيعة كافياً لذلك.
ومن الشواهد على أنّ البيعة للمعصوم يعقل أن تكون بروح تأكّد المعصوم من طاعة المبايع، لا بروح انتزاع ولاية الحكومة منه، أنّ آية بيعة النساء الواردة في القرآن الكريم واضحة في أنّ أكثر ما بايعت النساء النبيّ (صلى الله عليه و آله) عليه ـ إن لم يكن كلّه ـ هي أحكام شرعيّة لا أحكام حكوميّة، وذلك من قبيل أن لا يشركن بالله ولا يزنين، في حين أنّ المبايعة على ولاية الحكومة بالنسبة للأحكام التشريعيّة الإلهيّة لا معنى لها.
الطريق الثاني: بعد أن نفترض عدم كفاية ما سبق كقرينة ولو عرفيّة على تفسير مغزى البيعة بمعنى التأكّد بنسبة مئويّة معقولة من وفاء المبايع وطاعته، لا بمعنى انتزاع حقّ ولاية الحكم منه، تصبح هذه البيعات في ذاتها مجملة؛ لأنّها من فعل المعصوم وليس من قوله، والفعل يقبل أكثر من تفسير واحد، فيكون المرجع عندئذ النصوص القرآنيّة أو الروائيّة التي تدلّ على تماميّة ولاية الحكم قبل البيعة أو على اشتراطها بالبيعة.
ونحن نقتصر هنا على ذكر ثلاثة نصوص قطعيّة الصدور واضحة الدلالة جميعاً في ثبوت ولاية الحكم قبل البيعة دون اشتراطها بالبيعة، اثنان منها من الكتاب والثالث سنّة قطعيّة.
أمّا الكتاب فنكتفي منه في المقام بآيتين:
الاُولى: قوله سبحانه وتعالى:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴾ 6، فقد عقدت هذه الآية المباركة الملازمة بين قضاء الله وقضاء الرسول من ناحية، وبين سلب الخيرة من المؤمنين والمؤمنات من ناحية اُخرى، وهذا يعني ولاية الحكم.
ومن الطريف ما قالة القائل من نفي دلالة هذه الآية على المطلوب، بنكتة أنّ هذه الآية إنّما دلّت على أنّه متى ما تمّ القضاء من قبل الرسول وجبت طاعته. وهذا صحيح؛ لأنّ الرسول معصوم لا يقضي بغير الحقّ ولا يقضي بغير ما له حقّ القضاء به، ولكن لم تذكر الآية أنّ الرسول متى يقضي فلا تنفي الآية كون قضاء الرسول مشروطاً بالبيعة.
أقول: أوّلاً: إنّ مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة أنّ طرف الملازمة ذات قضاء الرسول (صلى الله عليه و آله)، في حين أنّه لو كانت البيعة شرطاً في مشروعيّة القضاء لكان طرف الملازمة القضاء زائداً على البيعة. ففرق بين افتراض كون زمان وجود البيعة ظرفاً بحتاً للقضاء من باب إنّه لولا البيعة لعجز الرسول عجزاً تكوينيّاً عن تنفيذ قضائه وافتراض كون البيعة شرطاً في نفوذ القضاء شرعاً. فالأوّل لا ينفى بإطلاق الآية؛ لأنّ طرف الملازمة يكون حقّاً هو ذات القضاء، وليست البيعة إلّا ظرفاً للقضاء. ولم تذكر الآية أنّ القضاء متى وفي أيّ ظرف يتحقّق؟ ولكن الثاني يُنفى بالإطلاق؛ لأنّ معناه كون طرف الملازمة القضاء المقيّد بالبيعة لا ذات القضاء، والقيد منفيّ بمقدّمات الحكمة والإطلاق.
ثانياً: إنّ قضاء الرسول قد اُردف في الآية المباركة بقضاء الله، ولا شكّ أنّ نفوذ قضاء الله غير مشروط بالبيعة؛ لأنّ فرض اشتراط نفوذ قضاء الله بالبيعة يستلزم إمكان انحلال كلّ البشريّة عن جميع الأحكام الإلهيّة بترك البيعة، وعندئذ لا يحقّ لله تعالى أن يعذّبهم على المعاصي، وهذا ليس خروجاً من ضرورة المذهب فحسب، بل خروج من ضرورة أصل الإسلام. فإذا تمّ عدم تقيّد نفوذ قضاء الله بالبيعة فوحدة السياق في المقام تقضي بعدم تقيّد نفوذ قضاء الرسول بالبيعة، بل ظاهر الآية هو أنّها افترضت قضاء الله وقضاء الرسول أمراً واحداً أو أمرين متلازمين، فالآية كالصريحة في نفي شرطيّة البيعة لنفوذ قضاء الرسول.
والثانية: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ 7، فإنّ هذه الآية أيضاً كالصريحة في نفي شرط البيعة، لأنّ البيعة إن كانت بمعنى إعطاء الولاية بالعقد الاجتماعي رجع روحها إلى روح التوكيل، ويكون وليّ الأمر وكيلاً من قبل الاُمّة التي عيّنته للقضاء والحكم، ولا يصحّ أبداً لدى أبناء اللغة أن يقال: الوكيل أولى بالموكِّل من نفسه، بل يصحّ للموكّل في الفهم العقلائي العرفي عزل الوكيل متى ما شاء. إذن فالمفهوم من قوله: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ 7 هو ولايةٌ فوق ما يعطى بالتوكيل أو بالعقد الاجتماعي، إن هي إلّا ولاية أعطاها الله للمعصوم ولم يعطها الناس إيّاه بالبيعة. وليست هذه ولاية تبليغ الأحكام فحسب؛ لأنّ تعبير ﴿ ... أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ 7 يعطي معنى السلطة على النفس، وهذا أعلى ما يتصوّر من مستوى ولاية الحكم.
وأمّا السنّة: فنكتفي منها في المقام بنصّ الغدير الثابت بالقطع والتواتر، وهو قوله (صلى الله عليه و آله): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ...».
ومن الطريف ما قاله القائل من أنّ نصّ الغدير لم يعط لعليٍّ ولاية الحكم، وإنّما أعطاه ولاية التبليغ؛ لأنّ الرسول لم يكن يمتلك من الاُمّة حقّ ولاية الحكم عليهم لما بعد موته كي يعطيها لعليّ، فإنّ الاُمّة إنّما أعطته بالبيعة ولاية الحكم في مدى حياته ولم تُعطِها إيّاه ملكاً وراثيّاً أو أبديّاً يكون من حقّه أن يعطيه بلحاظ ما بعد وفاته لابن عمّه أو لأيّ إنسان آخر.
أقول: لو فرض إمكان هذا التفسير لنصّ الغدير لولا قول الرسول (صلى الله عليه و آله): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»، لكان من الواضح أنّ تفريع الرسول (صلى الله عليه و آله) إعطاء الولاية لعليّ (صلى الله عليه و آله) على كونه (صلى الله عليه و آله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم يبطل ذلك، لما أشرنا آنفاً من أنّ التعبير بـ﴿ ... أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... ﴾ 7 صريح في ولاية الحكم.
وإنّما تورّط هذا القائل في ما تورّط فيه من نفي دلالة نصّ الغدير على أساس توهّم كون ولاية النبيّ الحكوميّة مأخوذة من الناس بالبيعة، لا من الله ابتداءً.
وأطرف من ذلك ما قاله هذا القائل أيضاً من أنّ بيعة الناس في يوم الغدير لعليّ لم تكن بيعة له على السلطة والحكم، بل كانت بيعة له على ولاية التبليغ؛ وذلك لأنّ الاُمّة في زمان الرسول (صلى الله عليه و آله) لم يكونوا يمتلكون ولاية الحكم؛ لأنّهم كانوا قد نقلوها من أنفسهم إلى الرسول بالبيعة، فلا يملكون شيئاً من هذا القبيل كي يعطوه لعليّ بالبيعة. نعم، بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه و آله) رجعت ولاية الحكم إليهم وملكوها مرّةً اُخرى بانفساخ العقد أو انتهائه بموت طرف العقد وهو الرسول، فكان بإمكانهم أن يعطوها لعليّ بعقد آخر أو بيعة اُخرى.
أقول ـ بعد مماشاة هذا الاُسلوب من تسلسل التفكير وتسليمه ـ : إنّه كان من الضروري أن يقول: إنّ بيعة الناس لعليّ في يوم الغدير كانت بيعة على الحكم لا على التبليغ؛ وذلك لأنّ حقّ ولاية الحكم وإن كان بالأصل للناس حسب تصوّر هذا القائل ويعطى لشخص ما بالبيعة والعقد الاجتماعي حسب زعمه، ولكن الناس لم يكونوا قد أعطوا هذا الحقّ للرسول بعنوان ملك أيدي حتّى بلحاظ ما بعد موته، بل كانوا قد أعطوه بالبيعة بلحاظ مدّة حياته على ما مضى في الكلام الذي نقلناه عن هذا القائل آنفاً. إذن فالناس كانوا مالكين لأمرهم بلحاظ ما بعد موت النبيّ (صلى الله عليه و آله)، فلم لا يمكن لهم أن يعطوه لعليّ بالبيعة في يوم الغدير؟! وهم لا يريدون إعطاء ولاية الأمر لعليّ بلحاظ زمان حياة النبيّ كي يقال: إنّهم لا يملكون ذلك، لأنّهم أعطوه النبيّ (صلى الله عليه و آله)، وإنّما يريدون إعطاء ما يملكونه وهو ولاية أمرهم بلحاظ ما بعد موت النبيّ. أمّا البيعة مع عليّ لأجل التبليغ فأمر لا معنى له حسب تصوّرات هذا القائل؛ لأنّ ولاية التبليغ ليست ملكاً للناس كي يعطوه إيّاه، وإنّما هذا ما يعطيه الله لعليّ كما أعطاه للرسول منذ أوّل الرسالة وقبل حصول أيّ بيعة له.
بقيت في المقام شبهة التمسّك بآية الشورى وقد بحثنا هذه الآية مفصّلاً في كتابينا أساس الحكومة الإسلاميّة، وولاية الأمر في عصر الغيبة.
والذي نريد أن نقوله هنا هو أنّه لا يمكن التمسّك بهذه الآية لإثبات رأي القائل الذي بحثنا رأيه؛ وذلك لأنّه لو صحّت دلالة الآية على حقّيّة مبدأ الشورى لتحقيق ولاية الأمر، وفرض أنّ ذلك يشمل حتّى ولاية المعصوم، لكان معنى ذلك أنّ بيعة المعصوم ليست واجبة على الاُمّة؛ إذ لا معنى للشورى في الواجبات، بل عليهم أن يبايعوا بلا مشورة في حين أنّ هذا القائل على رغم أنّه يرى ولاية الأمر للمعصوم مشروطة بالبيعة يعتقد أنّه مع وجود المعصوم تجب على الاُمّة بيعته. ولو فرض أنّ أحداً ربط ولاية الرسول (صلى الله عليه و آله) للحكم بالبيعة، وقال أيضاً: إنّ بيعته غير واجبة فتُجعل بيعته وعدم بيعته رهناً للشورى، لما كان ذلك خروجاً عن المذهب فحسب، بل كان خروجاً عن الإسلام.
وختاماً بودّي أن أتشرّف بذكر دعاء ورد استحباب قراءته في كلّ يوم بعد صلاة الصبح:
«اللّهمّ بلّغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وبرّها وبحرها، وسهلها وجبلها، حيّهم وميّتهم، وعن والديّ وعن وُلدي وعنّي من الصلوات والتحيّات زنة عرش الله ومدادَ كلماته ومنتهى رضاه، وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللّهمّ إنّي اُجدّد له في هذا اليوم وفي كلّ يوم عهداً وعقداً وبيعة في رقبتي. اللّهمّ كما شرّفتني بهذا التشريف وفضّلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصلّ على مولاي وسيّدي صاحب الزمان، واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابّين عنه، واجعلني من المستشهَدِين بين يديه طائعاً غير مُكرَه، في الصفّ الذي نعتّ أهله في كتابك كأنّهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللّهمّ هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة».
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين 8.
۱۸. محرّم الحرام. ۱٤۱٦ هـ
- 1. نهج البلاغة: ٥٤۹ بحسب طبعة الفيض.
- 2. نهج البلاغة: ۸۳۱، بحسب طبعة الفيض.
- 3. وقعة صفّين: ۲۱ بحسب طبعة قم.
- 4. نهج البلاغة: ۸۳٥، طبعة الفيض.
- 5. نهج البلاغة: ۱٠۷٠، طبعة الفيض.
- 6. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 36، الصفحة: 423.
- 7. a. b. c. d. القران الكريم: سورة الأحزاب (33)، الآية: 6، الصفحة: 418.
- 8. المصدر : موقع سماحة المرجع الديني السيد كاظم الحائري.