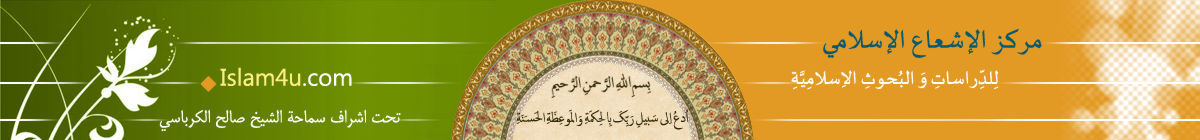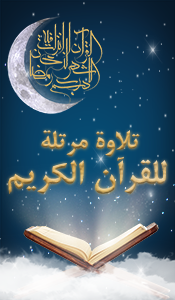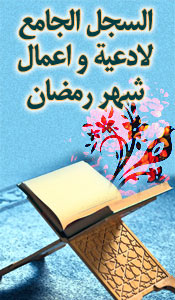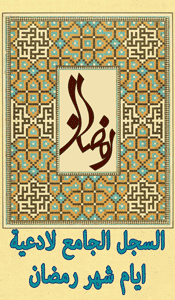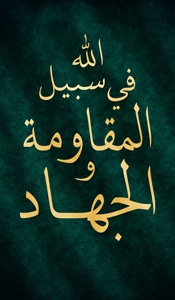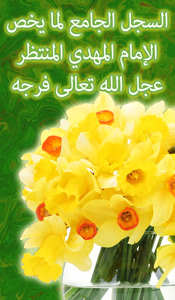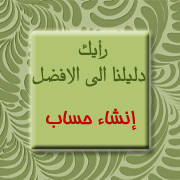حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
الإسلام وما بعد الحداثة.. رؤية غربية
في سنة 1997م نشر أستاذ الإسلاميات في الجامعات الألمانية راينهاد شولتسه دراسة مهمة بعنوان (هل توجد حداثة إسلامية؟)، ضمت إلى كتاب حول الإسلام والغرب صدر في فرانكفورت لمجموعة من الباحثين الألمان.
كشفت هذه الدراسة عن أفق في العلاقة بين الإسلام وما بعد الحداثة، أوسع وأكثر أهمية من الأفق الذي أشار إليه أكبر أحمد في كتابه (الإسلام وما بعد الحداثة.. الوعود والتوقعات).
ويبدو أن أكبر أحمد لم يتعرف على هذه الدراسة التي لم يرد ذكرها في كتابه، مع أنه صاحب إطلاع واسع على النتاج الغربي الفكري والأدبي والسياسي المتصل بالعلاقة بين الإسلام والغرب، ولو تعرف على هذه الدراسة لوجد فيها مدخلاً حيوياً في تدعيم موقفه، وتطوير رؤيته في العلاقة بين الإسلام وفكرة ما بعد الحداثة، وهي القضية التي أبدى لها حماساً واضحاً، وأقام كتابه لتأكيدها والدفاع عنها.
في هذه الدراسة كشف شولتسه عن المسار الفكري الذي كانت عليه ثنائية الإسلام والحداثة في منظورات الحداثة الغربية، وكيف تغير هذا المسار الفكري وانقلب بصورة كبيرة في منظورات ما بعد الحداثة.
في منظورات الحداثة، يرى شولتسه أن ثنائية الإسلام والحداثة كانت محكومة بثنائية سابقة عليها، وجاءت متأثرة ومتصلة بها، وهي ثنائية التقليد والحداثة، التي أخذت طريقها إلى البحوث الاستشراقية في خمسينات وستينات القرن العشرين، وذلك في إطار ما عرف بنظريات التحديث.
وكانت ثنائية التقليد والحداثة في نظر شولتسه هي الوسيلة التي وقع عليها الاختيار لتفسير الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية، فالتقليد كان يرمز إلى ذلك الموجود في المجتمعات غير الأوروبية، بينما ترمز الحداثة إلى ما ظهر من جديد في الغرب، وبموجب هذا الزعم أصبحت الحداثة تفسر دائماً في المجتمعات غير الأوروبية، كشيء براني قادم من أوروبا، حتى باتت ثنائية تقليد وحداثة تشير إلى ثنائية غرب ولا غرب.
وعندما تم اعتماد ثنائية التقليد والحداثة بوصفهما أداتين تحليليتين كان لابد في تصور شولتسه أن يتقرر التسليم بتدخل قادم من الخارج بوصفه أمراً لا مفر منه، وتجمعت في مفهوم التقليد أشكال من التصورات الرومانسية مثل مجتمعات قروية، مجتمعات قبلية، طقوس وشعائر، اقتصاد ريفي يفتقر إلى الآلة، وهي ما أصبحت تمثل المؤشرات الدالة على التقليد.
ومنذ أواخر السبعينات وجد شولتسه أن الحداثة دخلت كعنصر تصنيف في مجال العلوم الاجتماعية، ووضع الإسلام في الطرف المقابل لها، وعدوهما من أدوات التصنيف في العلوم الاجتماعية. في حين يرى شولتسه أن هذا التصنيف نادراً ما كان ملائماً لوصف الحقائق الاجتماعية وصفاً تحليلياً، وإن استمرار هذه الثنائية لوصف المجتمعات غير الأوروبية لا يمكن فهمه بشكل صحيح إلا من خلال كون الحداثة الغربية ما تزال بحاجة إلى نقيض لكي تستطيع أن تفهم نفسها.
أما في منظورات ما بعد الحداثة، وهذا ما يعنينا بشكل أساسي، حيث يرى شولتسه أنه أجربت في الإطار النقدي لنظرية ما بعد الحداثة إعادة تقييم جذرية لمفهوم الحداثة، فتح المجال لتفسيرات جديدة للثقافات الإسلامية الحديثة والمعاصرة، وساهم في انعتاق الحداثة من بنيتها التناقضية، وتلاشي ذلك الفصل الذي طالما رأيناه بين الثقافات الغربية وغير الغربية ولم يعد من المبرر الزعم بأن الحداثة هي شأن غربي، والتقليد شأن شرقي.
وعلى هذا الأساس يصل شولتسه إلى تثبيت نتيجة في غاية الأهمية هي أن الحداثة لم تعد امتيازاً غربياً، وإنما كانت عملية عالمية واسعة النطاق، وبالتالي فقد بات من الممكن وجودها في السياقات الأخرى كما في السياق الغربي. ولعله كان علينا أن نتكلم بصيغة الجمع عن حداثات، أو أنه كان علينا أن نستوعب الحداثة بوصفها عملية تاريخية عالمية، تنطوي على أشكال تعبيرية شديدة التباين في الثقافة المختلفة طالما أن تشكلها كان دائماً يتم في إطار تراث معين.
وقبل أن يختم شولتسه دراسته النقدية القيمة أعاد طرح التساؤل الذي عنون به هذه الدراسة: فهل توجد حداثة إسلامية؟
وجاءت الإجابة، وهي المحصلة النهائية، نعم توجد حداثة إسلامية، ولكن في منظورات ما بعد الحداثة1.
- 1. الموقع الرسمي للأستاذ زكي الميلاد و نقلا عن صحيفة عكاظ، العدد 15671.